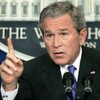Facebook
Facebook
 Twitter
Twitter
 YouTube
YouTube
 Telegram
Telegram
كيف يتجنب الشارع العربي مستقبلاً الصراخ الذي لا يثير غير الغبار؟
-1-اليوم، بعد أن سكتت المدافع، واختفى هدير الطائرات المقاتلة من سماء غزة المحترقة، وأعلنت الفصائل الفلسطينية وقف القتال، وهمد هيجان الشارع العربي والإسلامي، وانتظر الجميع من الدولة العربية الغنية المعونات لإعادة إعمار غزة، كما سبق وحدث في لبنان عام 2006، أصبح الحديث عن مستقبل الشارع العربي الذي كان بركاناً فخمد، ضرورياً ومطلوباً.
يُحدد تقرير التنمية البشرية، الذي صدر عن الأمم المتحدة في 2002 ، أهم ملامح الأمن القومي العربي بالمؤشرات التالية:
1- العجز الرسمي العربي عن إحياء الأمن القومي العربي نظرياً وعملياً.
2- الثقل العسكري والسياسي والاقتصادي الأجنبي بعامة والأمريكي خاصة على العالم العربي. ومواصلة إسرائيل أداء دورها كمؤسسة متفوقة عسكرياً وتقنياً، ومحتكرة للسلاح النووي، ومدعومة من أمريكا حتى هذه اللحظة.
3- غياب أية محاولة لتعديل هذا الوضع السيئ، رغم توفر العوامل اللازمة.
فما هو أثر هذه المؤشرات السيئة، التي لا تبشر بالخير على مستقبل الشارع العربي؟
-2-
سوف يبقى الشارع العربي بمثابة الرابطة التاريخية، التي تعتمد على عنصرين رئيسيين: الإسلام والقومية. وفي حالة انحياز الشارع العربي نحو الإسلام، فهذا يعني أن الجماعات الإسلامية/السياسية، استطاعت أن تتغلب على الجماعات القومية، وتنتزع منها الشارع العربي. وهو ما كان قائماً قبل أيام، بمناسبة حريق غزة المروّع. وخاصة أن المقاومة في غزة تُنسب إلى الجماعات الإسلامية/السياسية، وليس إلى الجماعات القومية. وبذا أصبح الشارع العربي الآن، يميل إلى كفة الجماعات الإسلامية/السياسية، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وفي بعض أقطار بلاد الشام. كذلك سيحصل العكس إذا ما تم الأمر للقوميين كما كان عليه الحال في فترة الخمسينات والستينات أثناء حكم عبد الناصر، وما سُمّي بـ "المد القومي الناصري". وسيبقى التنافس بين هذين الفريقين في قيادة الشارع العربي، وتحديد شعاراته الدينية أو القومية، أو الاتفاق على شعارات قومية/إسلامية. وستبقى القضية الفلسطينية هي المعادل الموضوعي لحركة الشارع العربي، والقاسم المشترك الأعظم فيه، كما كانت منذ ستين سنة، وكما ستظل، ما دام الصراع الفلسطيني – الفلسطيني، والصراع الفلسطيني – الإسرائيلي قائمين على هذا النحو، وشاغلان العرب عن كثير من قضاياهم الحيوية، التي تحتاج إلى تفرغ، ومال لحلها، فيما القضية الفلسطينية منذ ستين عاماً، تستنزف من جهد العرب السياسي والدبلوماسي والمالي القدر الكبير، دون حل أو زحزحة، بل تزداد تعقيداً وتشاؤماً وضياعاً.
-3-
في الستين سنة الماضية، كانت - وما زالت - القضية الفلسطينية هي سبب الشقاق والخصومات العربية. وهي العائق الأساسي في طريق الأمن والاستقرار في العالم العربي، وبالتالي عائق غير مباشر للتنمية العربية، في مختلف المجالات.
وكان شعار: "لا صوت يعلو فوق صوت المعركة"، هو الشعار السائد خلال تلك الفترة، وما زال سائداً حتى يومنا هذا. وهو بمثابة "قميص عثمان" الذي يُرفع في مناسبات متعددة ومختلفة، لسدِّ كثير من الأبواب. وأصبح العالم العربي يصبُّ جُلَّ اهتمامه على كيفية حل القضية الفلسطينية التي كانت – وما زالت – كالكرة، التي تتقاذفها أرجل فريقين في ملعب السياسة العربية والعالمية.
لكن الملاحظ، أن إسرائيل طرف النزاع الآخر، لم تُعقها القضية الفلسطينية، ولا تهديد العرب لها، ولم تَحُلْ بينها وبين تنميتها وازدهارها. فخلال الستين عاماً الماضية، أصبحت إسرائيل تملك أقوى جيش في المنطقة، وأقوى اقتصاد، وأعلى دخل سنوي للفرد، ولديها ثلاثاً من أشهر الجامعات في العالم، ومن بين العشرين الأوائل، في التقرير الذي نشر عن أفضل 400 جامعة في العالم، ولم تكن أية جامعة عربية من بينها. وهذا كله مما يدفع إلى التساؤل المؤلم والحزين وهو:
- هل كانت القضية الفلسطينية الصخرة، التي تكسرت عليها موجات الإصلاح والتغيير، أم أن الإصلاح والتغيير، لم يصل إلى حد الموج الكاسح بعد؟
-4-
إن حراك الشارع العربي مستقبلاً، سيكون من الصعوبة بمكان، حيث أن الفساد السياسي والمالي والإداري يزداد في العالم العربي يوماً بعد يوم، وبالتالي فإن العنف يزداد تبعاً لذلك. إضافة إلى أن قوانين الطوارئ المعمول بها في بعض الدول العربية، سوف تظل سيفاً مسلطاً على رقاب الشارع العربي، وعلى كل عمل سياسي علني محتمل.
وحتى لو تمَّ السماح للشارع العربي أن يتحرك حراكاً محدوداً، فهذا الحراك لن يفيد كثيراً، بل من الممكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية، وذلك لصعوبة انضباط هذا الشارع، نتيجة لفوضى الحياة العربية بكل مناحيها. فليس كل من نزل إلى الشارع يستطيع أن ينضبط عاطفياً وسياسياً.
-5-
إن أثر الشارع العربي ودوره الفعَّال والمضمون، بعيداً عن تدخل الأنظمة العربية، هو في المقاطعة الاقتصادية الفعلية الذاتية والشخصية، بعيداً عن القرارات الرسمية، ومن غير انتظار لها. ولكن المقاطعة الاقتصادية، عملية تحتاج إلى وعي، وتنظيم وضبط للنفس، وقدرة هائلة على الاحتمال والشجاعة، ربما تفوق ما تتطلبه المقاومة المسلحة، لا سيما وأن معظم ما نستعمله، ونأكله، ونشربه، ونلبسه، هو من صناعة الغرب.
والمقاطعة السلمية هي ما فطنت إليه معظم شعوب العالم لمقاومة أعدائها. فقد قاطعت شعوب الحلفاء في الحرب العالمية الثانية ايطاليا الفاشية، وألمانيا النازية. وكان لهذه المقاطعة أثرها الايجابي لصالح شعوب الحلفاء وحكوماتها.
وقاطعت الهند البضائع الانجليزية، ضمن حركة المقاومة السلمية، أو فلسفة اللاعنف "الساتياراها"، التي قادها الزعيم غاندي ، وهي مجموعة من المبادئ تقوم على أسس دينية وسياسية واقتصادية في آن واحد، ملخصها الشجاعة، واللاعنف. وتهدف إلى إلحاق الهزيمة بالمحتل عن طريق الوعي الكامل والعميق بالخطر المحدق، وتكوين قوة قادرة على مواجهة هذا الخطر باللاعنف أولاً.
وأثناء الحرب الباردة، قاطع المعسكر الرأسمالي الغربي المعسكر الاشتراكي الشرقي. ولا تفتأ أمريكا - كأكبر قوة اقتصادية في العالم - تستعمل سلاح المقاطعة الاقتصادية ضد أعدائها في كوبا، وإيران، والسودان، وكوريا الشمالية.
واستعملت بريطانيا المقاطعة الاقتصادية ضد الأرجنتين، في حربها من أجل استرداد جزر "الفوكلاند" في 1982. وكان قرار البريطانيين مقاطعة البضائع الأرجنتينية أقوى من الأسطول البريطاني، وأقوى من قرار مجلس الأمن 502 ، القاضي بانسحاب الأرجنتين من هذه الجزر.
فهل من عقلاء في العالم العربي، يقودون الشارع العربي إلى المقاومة السلمية، بدلاً من هذا الصراخ، الذي لا يثير غير غبار الأرض؟