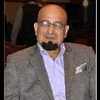Facebook
Facebook
 Twitter
Twitter
 YouTube
YouTube
 Telegram
Telegram
المثقف كأب حنون لشعبه في زمن الضياع
سأحصر كلامي ضمن المثقف الإنساني الذي يرى نفسه بدرجة أو بأخرى، باحثاً ومحارباً من أجل وصول الحقيقة والقيم العليا، والتي يراها ضرورة لا مفر منها من أجل سعادة مستقرة للبشرية.
قد تبدو للبعض هذه صورة عفا عليها الزمن، لكن الإنسان كان ومازال بحاجة إلى ضوء لامع بعيد يهتدي به، كما تحتاج السفن ضوء الفنار في الليالي العاصفة. فربما ليس من الصعب عليه أن يتحرك في حياته اليومية، لكن الحفاظ على الإتجاه العام الصحيح خلال تلك التفاصيل أمر آخر.
لا ينتظر المثقف من هذه المهمة أن تكون سهلة أو جميلة، رغم أنها لا تخلو من المكافآت الكبيرة بالإحساس بالإعتزاز بالنفس والدور الشريف الذي يقوم به في مجتمعه، ولكنها بكل تفاصيلها حرب حقيقية وسوف يخرج منها المحارب مثخناً بالجراح وبالغبار على وجهه وشعره والإحمرار في عينيه، وكما يقول نيتشة: "ليس لمحارب أن يطالب بأن يعامل بالمراعاة"!
الأجمل والأشرف
من الأسهل و“الأجمل” كثيراً أن نختار بدلاً من تلك الحرب، ما تتيح لنا ثقافتنا من فرص، حتى ضمن الكتابة نفسها، فنكتب عن ما ينفعنا نفسياً ومادياً وثقافياً ويتيح تجميع المنافع والتقدير الإجتماعي، وليس إلى معركة الحقيقة الحاضرة، حيث الأحداث العادية والصراعات المشتبكة والتشهيرات التي لا يرتجى منها سوى الأذى على المستوى الشخصي. أن لوحة ارسمها لن تكلفني أكثر من الوقت اللازم لكتابة مقالة سياسية معقدة محشوة بالمصادر، وأحصل من تلك اللوحة، حتى أثناء عملي بها، على شحنة من الإرتياح والسعادة بدلا من التوتر وحرق الأعصاب في الكتابة عن حقائق مؤلمة. ربما تمكنت من بيع اللوحة لكن محاولة بيع مقالة شريفة أمر عسير. وأهم من كل ذلك أن أحداً لن يشتمني ولا سلطة تراقبني وتتوجس تحركاتي بسبب لوحة أرسمها. لكن إن اختار جميع المثقفين والفنانين والشعراء طريق "الأجمل"، فإن أحداً في هذه الحالة لن يرشد هذا الشعب إلى الطريق ليتخذ موقفه وقراره الآني الذي يحتاجه لفهم الأحداث ومواجهتها عاجلا وبلا تأخير.
يقول شريعتي : "عندما يحترق بيتك فأن من يدعوك للصلاة خائن، وأي عمل غير إطفاء الحريق خيانة". وأجد في هذا القول مرشداً جميلاً فيما يجب التركيز عليه من جانب مثقف قرر أن يقف مع ضميره.
الشعوب يخلقها بشكلها الثقافي النهائي- وكذلك خياراتها إن كان لها أن تختار - مجموعة مثقفيها، إضافة إلى العوامل المادية الأساسية. فالمثقف وإن لم يكن الخالق المادي للشعب فهو الراعي له والموجه لطريقه، تماماً كما هو الأب بالنسبة للطفل. ليس في ذلك إهانة للشعب، فأهم ما يميز الشخص الكامل عن الطفل هو معرفة الأول بالحياة أكثر من الثاني، وهذا ينطبق بالتعريف على المثقف المميز بمعرفته النسبية الأكبر عن الباقين من الشعب. أن "الأجمل" للمثقف ان يذهب حيث يمكنه أن يزدهر ويحصد النجاح، لكن الأشرف أن يذهب إلى حيث يمكنه أن يأتي طفله بما يحتاجه.
الأب يقسو أحيانا لكن لا يهين
الأب يحنو على الطفل ويرعاه ويحرص على وصوله إلى مستقبله. إنه يعلمه ويساعده ويرشده إلى الطريق، لكنه يقسو أحياناً قسوة المحب الذي لا يسمح لتلك القسوة أن تصل حد الإهانة وخفض الروح المعنوية للطفل، وإضعافه وجعله عرضة للسقوط بيد المتربصين خلال مسيرة حياته. أن الأب الواعي المتمالك لأعصابه لا يسمح حتى لطفل صعب المراس أن يدفعه إلى تلك الحالة. لقد وضعته الحياة مسؤولاً عن هذا الإنسان ومصيره، وهو يقبل بتلك المسؤولية. لكن الآباء كثيراً ما ينسون ذلك في خضم الحياة، وكذلك يفعل المثقفون تجاه شعبهم.
ورغم أن المثقف لا يجب أن يقسوا على شعبه، فإنه لا يجب أن يكون رحيماً مع أعدائه أو مع الفاسدين من افراد ذلك الشعب. أنا اؤمن أن من واجب المثقف أن لا يلتزم بقواعد “التأدب” في الكتابة حينما يخدم ذلك التأدب تزييف الحقيقة. فحين نشرح لصوصية مسؤول كبير، يفترض أن نقول أنه لص وليس "مخطئ" أو "فاشل" أو امثالها من الكلمات المخففة للجرم، والتي تمنح حصراً للمسؤولين والأثرياء من اللصوص. هذا التمييز ليس جزءاً من ثقافة إنسانية حقيقية، بل هو مبدأ لا أخلاقي ومرفوض، لكنه صار معتاداً.
تجنب السخرية
من هنا نستنتج أن على المثقف التوقف عن المشاركة في السخرية من الشعب في كل الأحوال، سواء كانت سخرية محقة أو غير محقة. فعندما يكون وضع الطفل بحال يدعو الآخرين للضحك منه، فإن الواجب يدعو أبيه للبكاء بدلاً من ذلك! إن الأب السليم يدرك أنه هو الملام الأول على حال طفله. الملام هو المثقف!
يتلهى الكثير من المثقفين بتبادل السخرية بالإنترنت من شعوبهم، دون أن يدركوا أثرها السام على النفسية الإجتماعية، خاصة إن كانت تلك السخرية في محلها، وتستند إلى حقيقة. لو كان طفلك كسيحاً فلن تقهقه أمامه من طريقة مشيه الأعرج، أليس كذلك؟ فلماذا نقهقه بأعلى صوتنا ونتمتع بالضحك من تخلف شعبنا الكسيح بدلاً من أن نبكي عليه؟ السخرية لا تدفع إلى الإصلاح كما يوهم أنفسهم المتمتعون بالضحك ، إنها لا تدفع خاصة إن كثرت، إلا إلى اليأس. وهناك جهات متفرغة لكتابة السخرية من الشعب كما تبين مراقبتنا، وكما كتبنا أكثر من مرة. أذكر واحدة منها انتشرت بشكل كبير عن فتاة جاهلة إسمها "جعاز" وجدت نفسها في مطار بريطاني تحمل جواز سفر دبلوماسي ولا تعرف الإنكليزية ولا حتى عربيتها مفهومة، ثم يأتي الشرطي الإنكليزي شديد الأدب .. الخ. وادعى ناشروا هذه التفاهة أن مجلة بريطانية (لم تذكر) قد نشرت "الخبر"، ومن الواضح جداً من التفاصيل أنه "خبر" ملفق تماماً وأن اية مجلة لم تنشره، وأنه تم تأليفه قصداً لإهانة الشعب العراقي بأقصى صورة ممكنة.
علينا أن نتذكر أن هناك صناعة سينما كاملة تقوم على السخرية من العرب في أميركا، وقد بين الباحث جاك شاهين أنه من بين أكثر من فلم بحثها، أشارت إلى العرب بشكل أو بآخر، فان بضعة أفلام لا تزيد عن اصابع اليد الواحدة، قدمتهم بشكل محايد أو إيجابي! وقال أيضاً أن إهانة العرب تحقن في الأفلام حقناً حتى عندما لا يكون لموضوع الفلم علاقة بالعرب. تماماً كما حقن رجال الدعاية الأفلام بالتدخين وماركات السيارات لحساب الشركات المعنية. إنهم لا يدفعون مئات الملايين من الدولارات ورما المليارات بلا سبب. ونحن نقدم لهم الخدمة المجانية بنشرها مقابل أن نضحك قليلاً، وكان أجدر بنا أن نبكي، فهذا الكسيح الذي يضحك منه الآخرون، هو طفلنا!
لوم الشعب والفكرة الخاطئة: "إصلاح أنفسنا أولاً"
يجب أيضاً التوقف عن لوم الشعب إلا بما هو محدود ومدروس ويتوقع منه نتائج إيجابية. إن تحميل الشعب مسؤوليته تختلف عن تقريعه وإلقاء اللوم عليه أو ما يسمى عادة بإلقاء اللوم "على الذات"، وتستخدم عادة من قبل من يسعون في حقيقتهم إلى ردع اللوم عن الإحتلال وجرائمه ومؤامرات الدول الخارجية، إضافة إلى عدد كبير من الذين اقتنعوا بالفكرة الخاطئة وصاروا ينشرونها، ويدعون إلى أن "نصلح ذاتنا قبل أن نتهم الآخرين".
قد يكون "المرض فينا" والجرح جرحنا كما يقولون، لكن هذا لا يمنع، حتى ونحن مرضى أن نوقف اليد الخارجية التي تصب الملح على الجروح فتزيد مرضنا وألمنا. إن تأجيل الإلتفات إلى تلك اليد "حتى نشفى من أمراضنا" منطق أعوج يهدف إلى حماية تلك اليد وإعطاءها الفرصة الكاملة لاستكمال مشروعها المدمر، بحجة ضرورة أن "نبدأ بأنفسنا أولاً" أو أن نصلح اخلاقنا أولاً. لكن الأخلاق نتاج الوضع الإجتماعي وظروف الحياة أيضاً، وليست نتاج الثقافة والوعي وحدهما. لا يوجد مريض يقبل أن تستمر يد بضربه على رأسه بحجة أنه مريض، وأن معاناته الأساسية في نفسه وليس بسبب اليد! أن أي من دعاة "أن نصلح ذاتنا أولاً" لن يفعل ذلك إن كان هو الضحية بل يبادر إلى ردع من يزيده عناءاً. الصحيح هو العمل على كل الجبهات والتركيز على الأسرع تأثيراً منها، وهو بلا شك استئصال العوامل الخارجية المساعدة على المرض، ثم الإلتفات إلى الطرق الطويلة المدى، كتحسين المستوى الأخلاقي والتعامل الإجتماعي واحترام القانون وتعود الديمقراطية وحرية الآخر..الخ.
المريض يمكن أن يشفى
نعم نحن أمام شعب مريض ومجتمع مريض بشكل خطير، لكن الفكرة الأساسية التي يجب ان نفهمها ونتذكرها أن "المريض يمكن أن يشفى" و "المريض من حقه أن يدافع عن نفسه" حتى وهو في مرضه، وإلا لحكم على كل مريض بالموت وكل شعب متأخر بالإنقراض وكل وطن محتل بالتحطم. كل الشعوب التي نراها اليوم صحيحة ومعافاة، كانت يوماً ما مريضة، وربما بشكل ميؤوس منه، فلا يوجد شعب كان طوال تاريخه قوياً ومنتصراً. السؤال هو كيف تمكن المريض من القيام، وما هي الخطوات في الإتجاه الصحيح، والتي لا يعجز المريض عن القيام بها؟ هذه هي مهمة المثقف وما ينتظره منه شعبه المريض، فهو يحتاج الرعاية أكثر من السليم.
هيلين كيلر
لقد استمعت قبل فترة وجيزة إلى كتابين مقروءين لـ هيلين كيلر وهي تنقل لنا عالمها الغريب. وما أثار دهشتي البالغة، ليس فقط إنجاز ذلك الإنسان الذي فقد السمع والبصر وهو طفل صغير، وإنما من وقف معه وتمكن وفي القرن التاسع عشر، من تحويل هذا المعوق الميؤوس منه، إلى أديبة ومفكرة وموحية إنسانية هي هيلين كيلر. هل هناك أدعى لليأس من طفل لم يفقد بصره فقط، بل فقد معه سمعه أيضاً، وباتت أصابعه قناته الوحيدة حقاً للإتصال بالبشر؟ كيف يمكن حتى أن نتخيل أن نصل إلى هذا الإنسان في زنزانته المغلقة الشديدة الظلام، وألمغرقة في الصمت، لنوصل إليه ليس فقط صورة الحياة، بل ونتاج الإنسانية الأدبي والفلسفي والعلمي، إلى درجة ينجح فيها في النهاية في أن يقول كلمته ويدلو بدلوه! كيف نقارن أنفسنا ويأسنا، مع من وقف مع هذا الإنسان وقام بذلك الإنجاز الهائل؟ هكذا فعل والدي هيلين كيلر لها، وهي المعوقة حد اليأس، فكيف إذا كان طفلنا غير مصاب بأي عوق جسمي، وأنه قد أثبت يوماً أنه لا يقل قدرة على بناء الحضارات مثل أعظم الشعوب في العالم؟
صورة الأب ترشدنا
أن صورة الأب (أو الأم) والطفل ترشدنا إلى الكثير في كيف يجب التعامل مع شعبنا. وأهم شيء فيها أن الأب يرى نفسه في خدمة الطفل وليس الأب المنتفخ الذي يجب على الطفل تقديسه ويطالبه بالقيام بخدمته، كما يفعل المثقف العربي والعراقي غالباً. والنقطة الثانية أن الأب يحمل نفسه مسؤولية أي خلل يقع فيه الطفل، حتى لو كان الأخير معوقاً ومريضاً، لا ان يتسلى مع الآخرين بالسخرية من عوقه. فإن من واجب الأب أن يسعى قدر ما يستطيع لكي يواصل طفله الحياة باقل معاناة ممكنة، وأن يشتري له بأمواله التي هي أموال الطفل في النهاية، كل ما يساعده على أن يعيش حياةً مناسبة فيها من السعادة والقيمة الإنسانية أكبر قدر ممكن. لقد عاني هذا الشعب الويلات المتتالية، وفي كل مرة كان اعداءه يحصدون السنابل العالية من أبنائه المخلصين والواعين، فلا عجب أن ترك بيدره هزيلا "كعصف مأكول". إن أمامه معركة صعبة للبقاء على قيد الحياة وأياماً حالكة وتتكاثر المؤامرات عليه من كل جانب، وتنهال عليه الضربات من حيث لا يدري. دعونا لا نتركه يشعر باليتم أيضاً!
7 تشرين الثاني 2013